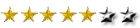لا أستمتع بتناول السياسة من قريب أو بعيد في مقالاتي، ولكن بكل أسف أكتشف إن كل حياتنا سياسة في سياسة، ويصبح الحديث عن الطماطم سياسة وكذا عن انفلونزا الخنازير وبالتالى فإن الحديث عن الإعلام والرياضة هو قمة الحديث فى السياسة،لذا فجميعنا يتعثر فيها دونما أى قصد وأبدو ضالعاً ومتهماً بالحديث عنها عندما أتناول موضوعاً عن الرياضة أو الإعلام على غير الحقيقة!!.
وأشهد أن بمصر علماء لا مثيل لهم ورجال دين أجلاء وأناس كثيرين طيبين ونابهين في كل التخصصات، يعملون بجد واجتهاد ويخشون الخالق فى كل صغيرة وكبيرة قدر ما استطاعوا!!.
وخلافاً لمن ذكرتهم في شهادتي، أتصور مصر قد أمست وأصبحت مسرحاً كبيراً يتحرك على خشبته مهرجين كًثًر وأناس اعتلوا كراسى الإدارة وتقدموا الصفوف على غير إرادتنا ورغبتنا، يفتقدون تماما لأي قدر من الرشد أو الاتزان، كل ما يقومون به هو العمل على تدمير كل جهود الآخرين الموجهه لخدمة مصر سواء الجهود الحالية أو جهود من سبقونا، وتصب كل أفعالهم مباشرة فى تدمير سمعة مصر أمام العالم كله وبدم بارد بكل ما أوتى هؤلاء من قوة، نظير بعض الجنيهات أو الكثير منها، من جيوب وعرق خدام مصر الحقيقيين وأهلها المخلصين!!.
كل مؤسسة أو شركة خاصة أو عامة، يحكمها أمران إذا هدف أصحاب العمل تحقيق النجاح لها:
1- أن يحكم المؤسسة النظام.. والنظام هنا إما لوائح وتعليمات المؤسسة، أو قانون الدولة الذي ينظم الحقوق والواجبات للجميع، أو كلاهما.
2- وجود الضمير.. وهو الذي يدفع بالعاملين للإجادة أو التكاسل، المخالفة من خلف ظهر المسئول أو الإخلاص بالرقابة الذاتية.
وعدم توفر الحد الأدنى من نتاج هذين العاملين، يعنى إصابة المؤسسة بالسوس الذى ينخر فى جسدها ويكتب شهادة وفاتها،وكلما زادت مساحة التجاوز كلما اقتربت النهاية.
واللوائح والتعليمات إلى جانب قانون الدولة، هما الجدار الأمني والمناعة الفعالة للمؤسسة التى تمنع القائمين على العمل من هدم المؤسسة عمدا أو حتى دون عمد على رؤوسهم، ولكن بدون إشراف وسيطرة من مستويات الإدارة المختلفة من داخل وخارج المؤسسة، تصبح كل إجراءات الوقاية عبئاً على المؤسسة تماما كأفعال المخربين!!.
والضمير كأى شيء يتم تنميته وتقويته، فالضمير أساسه الفطرة السليمة التى بثها الله فى كل نفس بحب السلام والخير للجميع، وكراهة العنف والشر للجميع، ودون أن يتحقق لهذه الفطرة الهارموني المناسب للتوافق مع الأسرة والبيئة المحيطة، يتم تهميش دور الضمير بقدر عدم توافق المجتمع مع القيم والأخلاق والمبادئ التى تحفظ للإنسانية قدرها فى أرضية التعامل بين البشر!!.
وظلت مصر بالنسبة لكل من يحيط بها أو بعيد عنها منارة ومركزاً مشعاً للإنسانية والشهامة الكرم وكل صفات النخوة والرجولة التى كانت تطبق عليهم جميعاً وسوياً بيد من حديد، من خلال سريان القيم والأخلاق والمبادئ السامية واحترام الانسان كالدم فى عروقها على مدار التاريخ!!.
إلا انه منذ أكثر من عقد، ضعفت قوة اليد للتشبث بكل ما سبق، فلم يعد للعيب القدر اللازم من الاحترام ورويداً رويداً قطعنا الحبل السرى مع الأصول التى ورثناها عن آباءنا وأجدادنا، وابتعدنا عن الله، فضللنا طريقنا، ولم تعد دعواتنا العشوائية والغير مخلصة تشفع لنا عنده، فأصبحت كل أمال أمة وشعب مصر، الفوز بمباراة أقل ما يقال عنها، أننا بأقل من نصف قدراتنا بكثير نستطيع تجاوزها دون حسابات كما يدور الآن!!.
وعودة الى عناصر نجاح أي منظومة عمل، فلتعدد مؤسسات العمل، ولاتساع مساحة انتشارها مع كثرة عدد العاملين فيها، أصبحنا نتحدث عن دولة وشعب، لذا تطلب الأمر ضمير للشعب إلى جانب اللوائح والقوانين، ليراقب عمله ويوجهه بل ويعدل سلوكه ويطوره وينميه، وما أسميه ضمير الشعب هذا هو "الإعلام"، ولسنا في حاجة لأن نتساءل لبداهة الإجابة: هل يمكن أن يخون الضمير صاحبه؟ بالطبع لا، وإلا ما سًمى بضميره.
فلماذا يخون ضمير الشعب صاحبه فلا يمنعه ولا يردعه عن سلوكه الحالي؟!.
ولأن لفظ الخيانة ذا وقع قاسى، فربما لم يخنه، ربما مرض الضمير، أو مات، أو اغتيل، والمؤكد أنه قد قتله السعى خلف القروش والجنيهات إلى جانب قصر النظر!!.
ولكننا نتوقع أن يكون للنظام – أى اللوائح والقوانين – دوراً حاسماً للحفاظ على استمرار المؤسسات، أو على الأقل الحفاظ عليها لصالح الإنسان، وبالتأكيد فإن النظام يحدد خطوطاً حمراء لحجم ومدى التجاوز، فإذا تم تجاوز الخطوط من قبل كل مستوى فالقانون هو الذى يحمى المتجاوز والمتجاوز في حقهم!!ّ.
ولكن ماذا يحدث إذا لم يكن جندى المرور فى موقعه عند الاشارة عندما تكسرها سيارة برغم الضوء الأحمر؟، وماذا إذا خالفت الضوء أكثر من سيارة؟، وماذا إذا كسرت نفس السيارات الإشارات التالية؟، وماذا إذا كان الجندي فى موقعه ويحدث ما يحدث؟، هل نستمر في تسمية الجندى والإشارة بـ "إشارة تنظيم المرور"؟، أم بـ "إشارة فوضى المرور"؟، وهل نتهم أحد بنتاج كسر الاشارة من إصابات وضحايا وخسائر مادية إلا نظام المرور ذاته والمسئولين عنه؟.
وهذا ما يحدث الآن تماما من "ضمير الشعب" أي الإعلام، فإعلام قد ترك الأخطاء تسرى كالمرض في جسد الرياضة، بل ولم يقبل ان يكون مراقبً وشاهداً او حتى فاعلاً في سبيل الإصلاح، بل أكل قلبه الحسد ألا يكون فاعلاً وينافس الرياضيين بكل تخصصاتهم، وأن يكون هو فاعل الحدث ومصدره، فبدلاً من رصد الحركة الرياضية، قرر أن يحل هو محلها وأن يكون هو الحركة الرياضية!!.
لا بأس.. ربما هي نزوة!!، فلننتظر حتى يًشفى منها ويهدأ!!، فبالتأكيد سيجد أن الجميع قد أشاحوا بوجههم عنه للبحث عن الرياضيين الحقيقيين، فيعود الإعلام إلى صوابه، فماذا كانت المفاجأة؟.
اكتشفنا أن الاعلام يريد الرياضيين مستمرين في ساحاتهم، ولكن كعرائس المسرح، ليقودهم ويحركهم هو كيفما شاء، وإذا لم تفلح حركتهم فى الميدان فيمكنه أن يلاحقهم فى حياتهم الخاصة وفى غرف نومهم ما المانع، المهم أن تدفع الجماهير له ليسمح لهم بالفرجة الحصرية!!.
لا شك أن ما يهدف اليه الإعلام أمر يخالف كل ما يصدر عن أى إعلام آخر فى أى مكان على سطح الأرض، بل ويخالف الناموس، سواء الخاص بحرفية الرياضة أو حتى بمهنة الإعلام، ولأن القائمين على الإعلام غير مؤهلين لتنفيذ حتى ما خططوا من مخالفات – إما لأنهم دخلاء ولا يملكون أيه ملكات تساعدهم أو هم من أصحاب المهنة ولكن بدون أى رصيد من الإبداع والموهبة - فلقد أصبحوا هم عرائس المسرح ولكن ليشاهدهم العالم كله ويضحك على ما يحدث بمصر!!.
والغريب انه لا وجود لعسكرى المرور ولا لضباط المرور ولا للإدارة العليا لجهاز المرور مع كل ما يحدث من كسر للإشارات، فهل يعنى ذلك أنهم موافقون على كسر نفس مجموعة السيارات هذه لكل الإشارات؟.
والغريب ان كل أبطال مسرح العرائس مسجلون سوابق لكسر الإشارات، أي أنهم كرروا أخطائهم ضد الرياضة والجماهير بجرأة وربما بوقاحة، فلا راعوا حقوق الرياضة أو الرياضيين، ولا راعوا حقوق الجماهير التى من المفروض انها تدفع لهم الآن لسبب آخر غير التواجد على مسرح العرائس، والغريب، أنه لا شكوى الرياضيين، ولا صرخات جماهير المسرح لفتت أنظار السادة مسئولى الإشراف والسيطرة على المسرح، ولا ظهر منهم أحد حتى الآن، برغم النزيف من جرح الحياء وخدش كرامة الانسان حتى وهو بمنزله وليس بالشارع، فقط لأنه تجرأ وأخطأ ووجه مؤشر التلفاز الى إحدى القنوات التى تعرض برنامج لأحد من هؤلاء المهرجين!!.
وأصبح الفضاء المصرى محجوز المقاعد لكل المشاهدين من خارج مصر لمتابعة مسرح العرائس، الذي يختلف عن كل مسارح العرائس، فمسرحنا مليء بكل ما يخالف الأدب والأصول بل والدين، فلدينا من يرصد المال على العام لإقناع فتياتنا وبناتنا الصغار أن ستر العورة هو التخلف والإرهاب وأن عليهن أن يخالفن تعليمات التربية القائم عليها أبائهن وأمهاتهن، فى حين أننا لم نسمع عمن وجه نظر العاريات والمتبرجات ونصحهن بالتستر ولو بصوت خفيض، ولدينا سباق دائم على شاشات البرامج الرياضية الفائز فيه لأطول الألسنة وأكثر مؤيدي تجاوزات الرياضيين الأخلاقية، وليس لدينا من ينادى بقليل من الأخلاق ويبادر بتقديم النموذج، ولدينا ممنوع الآذان فى أوقات الصلاة على تلك الشاشات، بينما نستغل أحداث الرياضة للتركيز على عرض إعلانات الأفلام الساقطة أخلاقياً وإعلانات حامد الجامد فهى المقدسة والتى يسبح بحمدها أصحاب هذه القنوات، فسهراتنا وبرمجنا العرائسية متنوعة، وتجعل من تسول له نفسه بمجرد التفكير فى مشاهدتها من الداخل والخارج، في قمة التقزز والاشمئزاز!!.
والى أن نفرغ من شرشحة الثنائيات والثلاثيات التى نشاهدها يوميا على شاشات "التلوث اللفظى"، والتى تثبت أننا فى مصر لدينا أصول كل الفيروسات وليس أنفلونزا الطيور فقط، ولكنها تتخفى خلف ماسكات وأقنعة، وما يصيبنا منها أشد من كل فيروسات الدنيا، لأن فيروس ضياع الأخلاق – عافا الله كل القراء منه – هو السبب فى كل ما حدث لأهل لوط وعاد وصالح، فالإعلام الفاسد هو أخطر أدوات الشيطان للتغلب على أبناء الصالحين ومؤسساتهم فادعوا الله جميعا أن نجد فى أسرع وقت طعوم هذه الفيروسات أو بمعنى أصح المسئول عن الإشراف والسيطرة، أو صاحب هذا المولد ليعيد ولو بعض الأمور إلى نصابها!!.
بعد كل هذا ألا تعرض مصر نموذجاً لقمة الحرية؟، ألا تظن صديقي القارئ أن إعلامنا باعتباره وسيلة نقل الانطباع عن بلادنا وزرع الانطباع المطلوب زرعه فى نفوسنا عن كل شيء، يستحق جائزة نوبل في قمة الأدب؟.
أعتقد أننا حصلنا أخيراً على التاج الذى ظلت الدول الغربية تعايرنا بامتلاكها له وحاجتنا إليه، ألا وهو "قمة الحرية"، فالآن لم يعد لهم عين لأن يطالبونا بقدر من الحرية، فلدينا فائضاً من الحرية يمكنه أن يغرق أوروبا والأمريكيتين، دون أن يتأثر رصيدنا بأى نقص!!.
ما رأيكم.. أليست مصر على قمة الحرية؟، هل تعجبكم هذه الحرية؟، إياكم والشكوى بعد ذلك من قلة الحرية.. التي يحسدنا عليها الجميع الآن.
...
وأشهد أن بمصر علماء لا مثيل لهم ورجال دين أجلاء وأناس كثيرين طيبين ونابهين في كل التخصصات، يعملون بجد واجتهاد ويخشون الخالق فى كل صغيرة وكبيرة قدر ما استطاعوا!!.
وخلافاً لمن ذكرتهم في شهادتي، أتصور مصر قد أمست وأصبحت مسرحاً كبيراً يتحرك على خشبته مهرجين كًثًر وأناس اعتلوا كراسى الإدارة وتقدموا الصفوف على غير إرادتنا ورغبتنا، يفتقدون تماما لأي قدر من الرشد أو الاتزان، كل ما يقومون به هو العمل على تدمير كل جهود الآخرين الموجهه لخدمة مصر سواء الجهود الحالية أو جهود من سبقونا، وتصب كل أفعالهم مباشرة فى تدمير سمعة مصر أمام العالم كله وبدم بارد بكل ما أوتى هؤلاء من قوة، نظير بعض الجنيهات أو الكثير منها، من جيوب وعرق خدام مصر الحقيقيين وأهلها المخلصين!!.
كل مؤسسة أو شركة خاصة أو عامة، يحكمها أمران إذا هدف أصحاب العمل تحقيق النجاح لها:
1- أن يحكم المؤسسة النظام.. والنظام هنا إما لوائح وتعليمات المؤسسة، أو قانون الدولة الذي ينظم الحقوق والواجبات للجميع، أو كلاهما.
2- وجود الضمير.. وهو الذي يدفع بالعاملين للإجادة أو التكاسل، المخالفة من خلف ظهر المسئول أو الإخلاص بالرقابة الذاتية.
وعدم توفر الحد الأدنى من نتاج هذين العاملين، يعنى إصابة المؤسسة بالسوس الذى ينخر فى جسدها ويكتب شهادة وفاتها،وكلما زادت مساحة التجاوز كلما اقتربت النهاية.
واللوائح والتعليمات إلى جانب قانون الدولة، هما الجدار الأمني والمناعة الفعالة للمؤسسة التى تمنع القائمين على العمل من هدم المؤسسة عمدا أو حتى دون عمد على رؤوسهم، ولكن بدون إشراف وسيطرة من مستويات الإدارة المختلفة من داخل وخارج المؤسسة، تصبح كل إجراءات الوقاية عبئاً على المؤسسة تماما كأفعال المخربين!!.
والضمير كأى شيء يتم تنميته وتقويته، فالضمير أساسه الفطرة السليمة التى بثها الله فى كل نفس بحب السلام والخير للجميع، وكراهة العنف والشر للجميع، ودون أن يتحقق لهذه الفطرة الهارموني المناسب للتوافق مع الأسرة والبيئة المحيطة، يتم تهميش دور الضمير بقدر عدم توافق المجتمع مع القيم والأخلاق والمبادئ التى تحفظ للإنسانية قدرها فى أرضية التعامل بين البشر!!.
وظلت مصر بالنسبة لكل من يحيط بها أو بعيد عنها منارة ومركزاً مشعاً للإنسانية والشهامة الكرم وكل صفات النخوة والرجولة التى كانت تطبق عليهم جميعاً وسوياً بيد من حديد، من خلال سريان القيم والأخلاق والمبادئ السامية واحترام الانسان كالدم فى عروقها على مدار التاريخ!!.
إلا انه منذ أكثر من عقد، ضعفت قوة اليد للتشبث بكل ما سبق، فلم يعد للعيب القدر اللازم من الاحترام ورويداً رويداً قطعنا الحبل السرى مع الأصول التى ورثناها عن آباءنا وأجدادنا، وابتعدنا عن الله، فضللنا طريقنا، ولم تعد دعواتنا العشوائية والغير مخلصة تشفع لنا عنده، فأصبحت كل أمال أمة وشعب مصر، الفوز بمباراة أقل ما يقال عنها، أننا بأقل من نصف قدراتنا بكثير نستطيع تجاوزها دون حسابات كما يدور الآن!!.
وعودة الى عناصر نجاح أي منظومة عمل، فلتعدد مؤسسات العمل، ولاتساع مساحة انتشارها مع كثرة عدد العاملين فيها، أصبحنا نتحدث عن دولة وشعب، لذا تطلب الأمر ضمير للشعب إلى جانب اللوائح والقوانين، ليراقب عمله ويوجهه بل ويعدل سلوكه ويطوره وينميه، وما أسميه ضمير الشعب هذا هو "الإعلام"، ولسنا في حاجة لأن نتساءل لبداهة الإجابة: هل يمكن أن يخون الضمير صاحبه؟ بالطبع لا، وإلا ما سًمى بضميره.
فلماذا يخون ضمير الشعب صاحبه فلا يمنعه ولا يردعه عن سلوكه الحالي؟!.
ولأن لفظ الخيانة ذا وقع قاسى، فربما لم يخنه، ربما مرض الضمير، أو مات، أو اغتيل، والمؤكد أنه قد قتله السعى خلف القروش والجنيهات إلى جانب قصر النظر!!.
ولكننا نتوقع أن يكون للنظام – أى اللوائح والقوانين – دوراً حاسماً للحفاظ على استمرار المؤسسات، أو على الأقل الحفاظ عليها لصالح الإنسان، وبالتأكيد فإن النظام يحدد خطوطاً حمراء لحجم ومدى التجاوز، فإذا تم تجاوز الخطوط من قبل كل مستوى فالقانون هو الذى يحمى المتجاوز والمتجاوز في حقهم!!ّ.
ولكن ماذا يحدث إذا لم يكن جندى المرور فى موقعه عند الاشارة عندما تكسرها سيارة برغم الضوء الأحمر؟، وماذا إذا خالفت الضوء أكثر من سيارة؟، وماذا إذا كسرت نفس السيارات الإشارات التالية؟، وماذا إذا كان الجندي فى موقعه ويحدث ما يحدث؟، هل نستمر في تسمية الجندى والإشارة بـ "إشارة تنظيم المرور"؟، أم بـ "إشارة فوضى المرور"؟، وهل نتهم أحد بنتاج كسر الاشارة من إصابات وضحايا وخسائر مادية إلا نظام المرور ذاته والمسئولين عنه؟.
وهذا ما يحدث الآن تماما من "ضمير الشعب" أي الإعلام، فإعلام قد ترك الأخطاء تسرى كالمرض في جسد الرياضة، بل ولم يقبل ان يكون مراقبً وشاهداً او حتى فاعلاً في سبيل الإصلاح، بل أكل قلبه الحسد ألا يكون فاعلاً وينافس الرياضيين بكل تخصصاتهم، وأن يكون هو فاعل الحدث ومصدره، فبدلاً من رصد الحركة الرياضية، قرر أن يحل هو محلها وأن يكون هو الحركة الرياضية!!.
لا بأس.. ربما هي نزوة!!، فلننتظر حتى يًشفى منها ويهدأ!!، فبالتأكيد سيجد أن الجميع قد أشاحوا بوجههم عنه للبحث عن الرياضيين الحقيقيين، فيعود الإعلام إلى صوابه، فماذا كانت المفاجأة؟.
اكتشفنا أن الاعلام يريد الرياضيين مستمرين في ساحاتهم، ولكن كعرائس المسرح، ليقودهم ويحركهم هو كيفما شاء، وإذا لم تفلح حركتهم فى الميدان فيمكنه أن يلاحقهم فى حياتهم الخاصة وفى غرف نومهم ما المانع، المهم أن تدفع الجماهير له ليسمح لهم بالفرجة الحصرية!!.
لا شك أن ما يهدف اليه الإعلام أمر يخالف كل ما يصدر عن أى إعلام آخر فى أى مكان على سطح الأرض، بل ويخالف الناموس، سواء الخاص بحرفية الرياضة أو حتى بمهنة الإعلام، ولأن القائمين على الإعلام غير مؤهلين لتنفيذ حتى ما خططوا من مخالفات – إما لأنهم دخلاء ولا يملكون أيه ملكات تساعدهم أو هم من أصحاب المهنة ولكن بدون أى رصيد من الإبداع والموهبة - فلقد أصبحوا هم عرائس المسرح ولكن ليشاهدهم العالم كله ويضحك على ما يحدث بمصر!!.
والغريب انه لا وجود لعسكرى المرور ولا لضباط المرور ولا للإدارة العليا لجهاز المرور مع كل ما يحدث من كسر للإشارات، فهل يعنى ذلك أنهم موافقون على كسر نفس مجموعة السيارات هذه لكل الإشارات؟.
والغريب ان كل أبطال مسرح العرائس مسجلون سوابق لكسر الإشارات، أي أنهم كرروا أخطائهم ضد الرياضة والجماهير بجرأة وربما بوقاحة، فلا راعوا حقوق الرياضة أو الرياضيين، ولا راعوا حقوق الجماهير التى من المفروض انها تدفع لهم الآن لسبب آخر غير التواجد على مسرح العرائس، والغريب، أنه لا شكوى الرياضيين، ولا صرخات جماهير المسرح لفتت أنظار السادة مسئولى الإشراف والسيطرة على المسرح، ولا ظهر منهم أحد حتى الآن، برغم النزيف من جرح الحياء وخدش كرامة الانسان حتى وهو بمنزله وليس بالشارع، فقط لأنه تجرأ وأخطأ ووجه مؤشر التلفاز الى إحدى القنوات التى تعرض برنامج لأحد من هؤلاء المهرجين!!.
وأصبح الفضاء المصرى محجوز المقاعد لكل المشاهدين من خارج مصر لمتابعة مسرح العرائس، الذي يختلف عن كل مسارح العرائس، فمسرحنا مليء بكل ما يخالف الأدب والأصول بل والدين، فلدينا من يرصد المال على العام لإقناع فتياتنا وبناتنا الصغار أن ستر العورة هو التخلف والإرهاب وأن عليهن أن يخالفن تعليمات التربية القائم عليها أبائهن وأمهاتهن، فى حين أننا لم نسمع عمن وجه نظر العاريات والمتبرجات ونصحهن بالتستر ولو بصوت خفيض، ولدينا سباق دائم على شاشات البرامج الرياضية الفائز فيه لأطول الألسنة وأكثر مؤيدي تجاوزات الرياضيين الأخلاقية، وليس لدينا من ينادى بقليل من الأخلاق ويبادر بتقديم النموذج، ولدينا ممنوع الآذان فى أوقات الصلاة على تلك الشاشات، بينما نستغل أحداث الرياضة للتركيز على عرض إعلانات الأفلام الساقطة أخلاقياً وإعلانات حامد الجامد فهى المقدسة والتى يسبح بحمدها أصحاب هذه القنوات، فسهراتنا وبرمجنا العرائسية متنوعة، وتجعل من تسول له نفسه بمجرد التفكير فى مشاهدتها من الداخل والخارج، في قمة التقزز والاشمئزاز!!.
والى أن نفرغ من شرشحة الثنائيات والثلاثيات التى نشاهدها يوميا على شاشات "التلوث اللفظى"، والتى تثبت أننا فى مصر لدينا أصول كل الفيروسات وليس أنفلونزا الطيور فقط، ولكنها تتخفى خلف ماسكات وأقنعة، وما يصيبنا منها أشد من كل فيروسات الدنيا، لأن فيروس ضياع الأخلاق – عافا الله كل القراء منه – هو السبب فى كل ما حدث لأهل لوط وعاد وصالح، فالإعلام الفاسد هو أخطر أدوات الشيطان للتغلب على أبناء الصالحين ومؤسساتهم فادعوا الله جميعا أن نجد فى أسرع وقت طعوم هذه الفيروسات أو بمعنى أصح المسئول عن الإشراف والسيطرة، أو صاحب هذا المولد ليعيد ولو بعض الأمور إلى نصابها!!.
بعد كل هذا ألا تعرض مصر نموذجاً لقمة الحرية؟، ألا تظن صديقي القارئ أن إعلامنا باعتباره وسيلة نقل الانطباع عن بلادنا وزرع الانطباع المطلوب زرعه فى نفوسنا عن كل شيء، يستحق جائزة نوبل في قمة الأدب؟.
أعتقد أننا حصلنا أخيراً على التاج الذى ظلت الدول الغربية تعايرنا بامتلاكها له وحاجتنا إليه، ألا وهو "قمة الحرية"، فالآن لم يعد لهم عين لأن يطالبونا بقدر من الحرية، فلدينا فائضاً من الحرية يمكنه أن يغرق أوروبا والأمريكيتين، دون أن يتأثر رصيدنا بأى نقص!!.
ما رأيكم.. أليست مصر على قمة الحرية؟، هل تعجبكم هذه الحرية؟، إياكم والشكوى بعد ذلك من قلة الحرية.. التي يحسدنا عليها الجميع الآن.
...